خذلان الحق
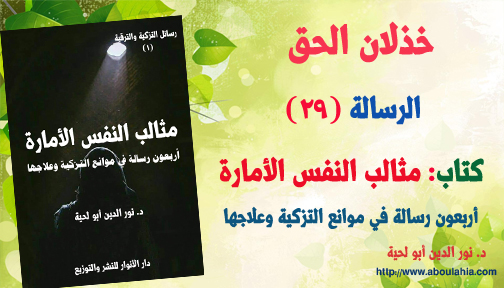
خذلان الحق
كتبت إلي ـ أيها المريد الصادق ـ تسألني عن تفسير ما ذكرته لك في بعض رسائلي السابقة مما سميته [خذلان الحق]، ومظاهره، ومنابعه، وكيفية تطهير أرض النفس الأمارة منه.
وجوابا لسؤالك الوجيه أذكر لك أن الموقف من الحق وأهله امتحان من الامتحانات الكبرى التي يمتحن الله بها إيمان عباده.. ذلك أنه لا يكفي أن يعرف المؤمن الحق، أو يذعن له، أو يسلم لأهله.. وإنما عليه أيضا أن ينصره، ويقف في صفه، ويكثر سواد أصحابه، لا سواد أعدائه.. ولا يقبل منه صدق الإيمان إلا ذلك.
ألا ترى ـ أيها المريد الصادق ـ ما فعله السحرة عندما تغلغل الإيمان إلى قلوبهم؛ فقد كان في إمكانهم أن يؤجلوا إعلان إيمانهم، ولا يبثوه في تلك اللحظات الحرجة، حرصا على أنفسهم إلى أن تحين الفرصة لهم، للقاء موسى عليه السلام، ليعلنوا إيمانهم حينها، أو يكتفوا بإيمانهم في قلوبهم؛ فالله تعالى يعلم السر وأخفى..
لكنهم لم يفعلوا.. وإنما راحوا يقفون ذلك الموقف البطولي الذي أشاد به القرآن الكريم، واعتبرهم لأجله نماذج صالحة للمؤمنين.. ولولا لم يفعلوا ذلك ما أشاد بهم القرآن الكريم، ولما ذكرهم.. لأن قيمة إيمانهم لم تكن في إذعانهم وحدهم للحق، وإنما في ذلك الإعلان الذي كان له تأثيره في كل من سمعه.
وهكذا أثنى القرآن الكريم على الذي أعلن إيمانه في الوقت الذي اقتضى منه الحق ذلك، فلم يخذل الحق، وإنما نصره أعظم نصرة، وذلك ما يثبت أن كتمانه للإيمان لم يكن لأجل حفظ نفسه، وإنما لأجل حفظ الحق الذي يحمله..
وقد ذكر الله تعالى خطبته البليغة في الملأ من قومه، وأمام فرعون وزبانيته، ومنها قوله: { أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا} [غافر: 28، 29]
وقد ذكر الله تعالى أنه حفظه بعد قيامه بواجبه في نصرة الحق، ليبين للمتخاذلين أن الناصر للحق قد يمن الله تعالى عليه بالموت في سبيل الله، مع الفضل العظيم الذي ينتظره بعده، وقد يمن عليه بالحياة ليعيش في سبيل الله، وفي كلاءة الله، ليؤدي واجباته التي كلف بها في نصرة الحق وأهله.
وهكذا ذكر الله تعالى ذينك الرجلين من قوم موسى عليه السلام، والذين خالفوا قومهم الجبناء، فبعد أن قال لهم موسى عليه السلام: {دْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [المائدة: 21]، وأجابه قومه بقولهم: {يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} [المائدة: 22]
حينها رأى ذانك الرجلان الصالحان أن السكوت في ذلك الحين خذلان للحق، فراحا يقولان: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]
وقد وصفهما الله تعالى بصفتين، تنطبقان على كل ناصر للحق، فقد وصفهما بأنهما: { رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} [المائدة: 23]
والرجولة بالمعنى القرآني لا تعني الذكورة، وإنما تعني الشهامة والنبل والمروءة وكل الصفات النبيلة التي تدفع صاحبها إلى نصرة الحق وأهله وفي أحرج المواقف، كما قال تعالى في وصف الصادقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ممن ينصر الحق بعدهم: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا } [الأحزاب: 23]
وأثنى بهذا الوصف على ذلك الرجل الشهم الذي جاء لينبه موسى عليه السلام إلى تآمر الملأ من قوم فرعون عليه، فقال: {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} (القصص:20)
وأثنى به على ذلك الشهم الذي جاء ينتصر لرسل الله، ويحث قومه على اتباعهم، قال تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ} [يس: 20 – 25]
وقد أشار القرآن الكريم إلى قتلهم له، وإلى استمراره في نصرة الحق بعد شهادته، قال تعالى: { قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ} [يس: 26، 27]
وهكذا يعتبر القرآن الكريم نصرة الحق وأهله من أكبر الموازين التي يوزن بها إيمان المؤمنين، ومرتبتهم من الدين، وصدق تحققهم بولاية الله، قال تعالى في بيان أقسام المؤمنين ودرجاتهم: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 74، 75]
فمع أن الجميع مؤمنون إلا أن الله تعالى فرق بين أولئك الذين هاجروا وجاهدوا ونصروا الحق، وبين المقصرين المتأخرين، قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 95، 96]
بل إن الله تعالى يفرق بين من نصر الحق في فترة البلاء، وبين من تأخر نصره له، فقال: { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [الحديد: 10]
وهكذا ورد في السنة النبوية المطهرة الكثير من التوجيهات التي تدل على الفروق العظيمة بين المنتصرين للحق، والخاذلين له، بحيث يمكن اعتبار الانتصار للحق ركنا من أركان الإيمان، وعلامة من علامات المسلم الحقيقي، الذي نجح في اختبارات الإيمان.
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحض على رعاية هذا الركن:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره)([1])، وفي رواية: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)([2])
وقال: (من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذلّه الله ـ عزّ وجلّ ـ على رؤوس الخلائق يوم القيامة)([3])
وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنّ الله يطعمه مثلها في جهنّم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، فإنّ الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)([4])
وفي حديث آخر عمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مثل كان معروفا في الجاهلية، وهو (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، فردده على مسامعهم، فاستغربوا، وقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تأخذ فوق يديه)([5])
وفي حديث آخر عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاريّ: يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهليّة؟)، قالوا: لا يا رسول الله! إلّا أنّ غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فلا بأس، ولينصر الرّجل أخاه ظالما أو مظلوما: إن كان ظالما فلينهه؛ فإنّه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره) ([6])
العلاج المعرفي:
إذا عرفت هذا ـ أيها المريد الصادق ـ فاعلم أن الله تعالى ذكر في كلماته المقدسة المعاني التي تعين على نصرة الحق وأهله، والتضحية في سبيل ذلك بكل شيء، وذلك عند ذكره لمواقف الناصرين للحق، والأسباب التي دعتهم لذلك.
ولعل أولها ما ذكره الله تعالى عن السحرة وجوابهم لفرعون، ففي كلمتهم القوية التي ألقوها أمام الجموع المحتشدة جميع المعارف التي يحتاج إلى تعميقها في نفسه كل من يريد أن يتخلص من هذا المثلب.
لقد ذكر الله تعالى ـ تمهيدا لذكر مقولتهم ـ التحدي الذي واجههم به فرعون، ليبين عظمة الموقف الذي وقفوه، فقال: { قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى} [طه: 71]
حينها، وأمام تلك التهديدات الشديدة، ومع أنه لم يمض على إيمانهم لحظات معدودة، ردوا عليه بثبات وصدق قائلين: { لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى} [طه: 72 – 76]
وهذه الكلمات المقدسة التي حكاها الله عنهم لم تكن مجرد كلمات، بل هي عقاقير وأدوية، بل هي صيدلية لكل المعاني الطيبة التي تملأ المؤمن بالقوة والشجاعة لينصر الحق، ويقف مع أهله غير مبال بما قد يصيبه في سبيله.
وأول تلك العقاقير ما عبروا عنه بقولهم: {لنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا} [طه: 72]، وهو يدل على أن إيمانهم كان مؤسسا على أدلة قوية، جعلته بالنسبة لهم واضحا بينا لا يمكن أن يجادلهم فيه أحد.. وذلك يدل على أن السبب في خذلان الحق هو ضعف الإيمان، وعدم حصوله على اليقين الكافي الذي يجعل صاحبه مستسلما استسلاما كليا لمقتضياته.
ولذلك كان أول العلاج هو تحقيق اليقين، وتحويل الإيمان من مجرد معارف ذهنية محدودة إلى حقائق يقينية بينة، يشعر بها صاحبها، بل يراها رأي العين.
ولذلك قالوا بعد ذلك: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [طه: 72]؛ فقد أدركوا أن الحياة التي يهددهم فرعون بسلبها منهم ليست سوى حياة دنيا، وأن هناك حياة أخرى تنتظرهم أشرف وأكرم، وأمرها ليس بيده، ولكن بيد الله تعالى.
ولذلك راحوا ينحازون إلى الجناب الإلهي لأن الحياة الحقيقية عنده، لا عند فرعون، ولذلك قالوا: { إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [طه: 73]
ثم ذكروا له العواقب التي ينالها المقصرون في نصرة الحق، أو المنحازون إلى الباطل، فقالوا: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [طه: 74]
وذكروا له في مقابل ذلك الجزاء العظيم الذي يناله من وقف مع الحق ونصره، فقالوا: {وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى} [طه: 75، 76]
وكل هذه الحقائق هي التي يمكنها أن تملأ النفس بالشجاعة والقوة، وتخلصها من الجبن والخور، حتى تستطيع أن تؤدي وظائفها المرتبطة بالموقف من الحق ونصرته.
ولذلك كان سعيك لتحصيل هذه المعاني ـ أيها المريد الصادق ـ هو العلاج الذي يطهر أرض نفسك من هذا الوباء الخبيث الذي أخبر الله تعالى أن كل الأمم ابتليت به.. فلا يكفي أن تدعي الإيمان، ما لم تقم بنصرة أهله الصالحين؛ وتواجه الناكثين والقاسطين والمارقين والبغاة وكل المحرفين والمنحرفين.
ولذلك يذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن المسلمين سيتعرضون للبلاء في هذا الجانب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده؛ فالاختبار سنة إلهية لتمييز الطيب من الخبيث، والنفوس الأمارة عن النفوس المطمئنة، قال تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [التوبة: 16]
وهكذا، فإن القرآن الكريم يحذر من حصول التمرد على قيم الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]
وهكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقوع التحريف في الدين، واستبدال قيم السلام والسماحة والأخلاق النبيلة فيه إلى القيم المنافية لها، والتي تحولت الأديان بسببها إلى أدوات للصراع والظلم والاستبداد، ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه، ويستنون بسنته، ثم يكون من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويعملون ما تنكرون)([7])
وأخبر عن الدور الذي يقوم به الساسة في التحريف، ذلك أنه لا يمكن للمستبدين الظلمة أن يمكنوا لأنفسهم في ظلال القيم الدينية الأصيلة؛ فلذلك يقومون بثورة مضادة على قيم الدين، لتتحول الرعية إلى سدنة للحاكم، ومطيعة لأمره ونهيه ولو على حساب قيم الدين الأصيل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب)([8])
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البغي لن يكون فقط في الجانب السياسي، وإنما سيمتد إلى الجانب الديني، وأن السلطات الظالمة، ستقرب من يخدمها في هذا الجانب، ليؤدي دوره في الثورة المضادة للدين، بل اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم أن البغي المرتبط برجال الدين أخطر من البغي المرتبط برجال السياسة؛ ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون)([9])
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسيلة التي يستعملها الأئمة البغاة لتحقيق ثورتهم المضادة على الدين، وهي تأويل القرآن، وتحريف معانيه لتنسجم مع مطالب السياسيين، وتحول الرعية إلى ذلك الشكل الذي حولها إليه فرعون، كما قال تعالى عنه: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ [الزخرف: 54]
ولذلك كله كان الاختبار الإلهي لهذه الأمة مرتبطا بمواجهة تلك التحريفات التي حصلت للدين، والبحث عن الدين الإلهي الحقيقي الذي لم يحرف، ولم يبدل، ونصرته، والدعوة إليه.
العلاج السلوكي:
إذا عرفت هذا ـ أيها المريد الصادق ـ فاجعل من نفسك جنديا للحق، ووطن نفسك على نصرته، مهما كانت الظروف والاختبارات التي تتعرض لها، ولو كان في ذلك حتفك، فقد قال الله تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب: 39]
وذكر مقولتهم لمن يخوفونهم من الناس: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]
وأخبر عن هداية الله ومحال تنزلها، فقال: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18]
ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يفعل ذلك، فيقتل، ليس شهيدا فقط، وإنما سيد الشهداء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)
وقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)([10])
ولهذا قرن الله تعالى بين الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس، وأخبر أن كليهما تعرض للأذى بل للقتل، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: 21]،
ولهذا فإن التفريط في مثل هذه الفرص لعوام المؤمنين، والتي تجعلهم في مرتبة واحدة مع الأنبياء والأولياء، خسارة عظيمة، واحتقار عظيم للنفس، كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله تعالى فيه مقال، فلا يقول: يا رب خشيت الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى)([11])
وقال: (ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه.. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) ([12])
ولهذا، فإن طريق الولاية ـ أيها المريد الصادق ـ لا يتحقق بالعزلة المطلقة عن الناس، أو الهرب من الإدلاء بالشهادة في حال الحاجة إليها، وإنما يتحقق بالمبادرة، والبذل والتضحية.
ولهذا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ـ في أحاديث كثيرة ـ أن الناجحين في الاختبارات الإلهية هم الذين يقفون في صف الحق؛ فينصرونه، ولا يخذلونه، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيكون أمراء من بعدي يعرفون وينكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك)([13])
وقال: (سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد على الحوض)([14])
وقال:(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع)([15])
وقال: (ما من نبي بعث الله في أمة من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقدون بأمره، ثم إنها تخلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يأمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل)([16])
وقال: (الجهاد أربع: الامر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والصدق في مواطن الصبر، وشنآن الفاسق)([17])
وقال: (خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه، يمنعكم من ذلك المخافة والفقر، ألا وان رحى الايمان دائرة، وان رحى الا سلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث يدور، ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب، ألا انه سيكون عليكم أمراء ان أطعتموهم أضلوكم، وان عصيتموهم قتلوكم)، قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: (كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير، موت في طاعة الله، خير من حياة في معصية الله) ([18])
وإياك ـ أيها المريد الصادق ـ أن تتوهم أن هذه الأحاديث مرتبطة بواقع تاريخي معين؛ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أن تنحصر تعليماته ونصائحه وتوجيهاته بواقع دون واقع، أو ببيئة دون بيئة..
فلذلك ابحث في واقعك عمن يمثلون الحق، أو ينصرونه، لتكون سندا لهم، ونصيرا يؤيدهم ويعينهم، وإياك أن تتوقف عن ذلك بحجة عدم تمييزك أهل الحق عن أهل الباطل، فقد وضع الله تعالى لأهل الحق علامات واضحة، لا يزيغ عنها إلا من اتبع هواه.
لقد قال الله تعالى يذكر تلك العلامات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة: 54]
فإن وجدت قوما ينصرون المستضعفين، ويواجهون
المستكبرين، ويتعرضون لكل أصناف الضغوط والعدوان بسبب ذلك، وهم مع ذلك في غاية الحلم
والأدب والأخلاق الرفيعة؛ فاعلم أنهم هم المقصودون؛ فإياك أن تفرط في نصرتهم..
وإياك أن يجرك الشيطان لعداوتهم.. فما أفلح من عاداهم، وقد قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم محذرا من ذلك: (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)([19])
([1]) مسلم (2564)
([2]) البخاري [فتح الباري]، 5( 2442) و اللفظ له، مسلم( 2580)
([3]) أحمد( 3/ 487)
([4]) رواه أبو داود( 4881) و أحمد ( 4/ 229)
([5]) البخاري [فتح الباري]، 5( 2444)، ومسلم ( 2584)
([6]) مسلم (2584)
([7]) رواه مسلم (1: 70)، وأحمد (1: 458، 461)
([8]) رواه الطبراني في المعجم، 20/90، مجمع الزوائد، 5/228.
([9]) رواه أحمد 6/441.
([10]) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما.
([11]) رواه أحمد وابن ماجة.
([12]) رواه أحمد والترمذي والحاكم.. وغيرهم.
([13]) رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف.
([14]) رواه النسائي والترمذي وصححه والحاكم.
([15]) رواه مسلم وأبو داود.
([16]) رواه أحمد ومسلم.
([17]) رواه أبو نعيم في الحلية.
([18]) رواه الطبراني في المعجم، 20/ 90، مجمع الزوائد، 5/ 228.
([19]) البخاري (8/ 131)



